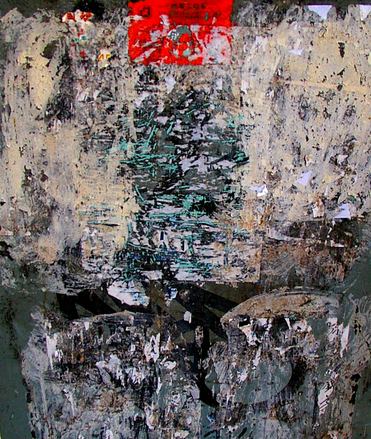
كانت الأسئلة تتزاحم خلف لساني ولا أعلم بأيِّها سأبدأ، ولكن بعد برهات من التّفكير رأيتُ أن أبدأ من الواقع الَّذي هو أمامي، فقد كانت مُعظم عناوين المُجلدات الَّتي أمامي تدور في فلك التّاريخ .. استفسرت منه إن كان مؤرخاً أو مهتماً بالتّاريخ؟ ولكن جواب العجوز لم يكن حاسماً فلم يؤكِّد أنهُ مؤرخ ولم ينفِ ذلك بل اكتفى بالقول إنَّه يملك الكثير من كتب التّاريخ!.
فأردفت بالقول: نعم كتُب التّاريخ شديدة الأهمية فهي تخبرنا بحقيقة ما حدث في العهود السّالفة، تنفس العجوز بعمق ثمَّ أغمض عينيه، وهو يستند براحتيهِ على السّرير الَّذي يرقد فوقهُ ثمَّ فتحهما كمن عاد للتو من رحلةٍ بعيدةٍ أو كأنَّهُ ذهب ليستشير أحداً ما في الحلم ثمَّ استيقظ ليجيب: بالنّظر إلى حالَّتي الخاصة، فإنَّ اقتنائي لكتب التّاريخ يندرج في مقولة "يجب أن تعرف ماذا يكتبه عنك أعداؤك" ورغم أني لا أحمل عداءً للمؤرخ إلا أنّهُ يُعلن العلاقة معي في إطار الحُكم الأخلاقيّ للعلاقة الإيجابية، فأنا من حيثُ طبيعتي لا أحمل تجاه الآخر قيمةً أخلاقيةً ما، فأنا لست حُبّاً، ولست كُرهاً، كما أني لست "معَ"، ولست "ضدًا"، أي أنني أندرج في علاقتي مع المؤرخ في إطار القيمة الأخلاقيّة السّالبة، وأحسن الغلام "ماكس فيبر" عندما قال: بأنَّ عمي العجوز يقف في علاقتهِ مع ما يحيطهُ على مسافة واحدة، فهو يضع نفسهُ في خانة "المحايدة التّقيميّة". ولكن ما يحدث أنّ المؤرخ لا يستطيع أن يقاوم إغراء إصدار الأحكام في ما يكتبهُ حولي، وإذا عُدت إلى هذه الكتابات فإنِّي أجدها في مجملها تجعل من حياتي الطَّويلة تسير في مسارب مؤطَّرةٍ بإيديولوجياتٍ متشاكسةٍ ومتضاربةٍ على نحوٍ يدعو إلى الضَّحك والدَّهشة، وهي بذلك بشكلٍ أو بآخرٍ تُعلن العداء على طبيعتي الحياديِّة، وترفض أن تعترف بهذه الخصوصيِّة الَّتي هي هويتي الحقيقية، والَّتي من غيرها أفقد كينونتي الخاصة، وإذا الأمر كما قلت لك فإنَّ كتب التّاريخ تصبح بالنسبة لي هي الوثائق على افتراءات المؤرخ حول طبيعتي الأصلية، ولذلك كان لا بُدَّ لي من معرفة ما يكتبهُ حولي هؤلاء القوم الَّذين يناصبوني العداء رغم أنَّي لا أرى فيهم إلا كما يرى المسافر في مسافرٍ آخر يسير إلى جنبه.
مقدمة:
تعددت أسباب فهم مسألة المخاطر واستفاض حولها النقاش وكثرت بخصوصها زوايا النظر. وهي الأمور التي تجد تفسيرها أولا في كون دراسة المخاطر أضحت علما قائم البنيان، متعدد المستويات science pluridisciplinaire يسبر الأغوار العميقة لشتى تخصصات العلوم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاستراتيجية، كما يمتح منها مختلف الآليات المنهجية التي يتوسل بها في تحليلاته ودراساته المتعلقة أساسا بمفهوم "المخاطرة" كمفهوم متعدد الأبعاد[1]، ثم ثانيا بالنظر إلى التصنيفات المتنوعة والتيبولوجيات المتشعبة المرتبطة بالمخاطر :السياسية،الاقتصادية، البيئية، الطبيعية، الأمنية ...والتي تحتم على كل نوع من هذه المخاطر البحث عن النمط الخاص للتعامل معه؛ حيث يفتح تصنيف المخاطرة عالما على جانبي التمييز الواضح بين المعرفة وعدم المعرفة ، بين الصحيح والخطأ، الخير والشر. فقد تشذرت الحقيقة الواحدة إلى مئات الحقائق النسبية التي نتجت عن القرب من المخاطرة والتأثر بها [2] .ثم ثالثا وأخيرا، لاعتبار هذا التعامل المنتظر من التفكير في مجابهة المخاطر المحدقة يستلزم بالضرورة طرح جوانب "فهمية" متعددة كمدخلات لإيجاد الصيغ التدبيرية الناجعة كمخرجات على مستوى أية مخاطرة من المخاطر المحتملة [3].وهي المخرجات التي غالبا ما تصطدم برعونة جديدة واستهتار بالمخاطرة بسبب فشل مواصفات وشروط حسابها ومعالجتها مؤسسيا[4]
فارقني رمضان فجثوت أتأملني. من أنا، بل ما أنا؟ نقدٌ بين الأيدي والجيوب؟ رقم لافت بطرف سيارة؟ قلم مغروز في جيب؟ مسبحة تتقلب وتدور؟ حاشية مزخرفة في عباءة؟ ضحك دائم وصوت يصُم؟ ذراع مفلتة باطشة؟ خبر مجتزأ من هنا وهناك؟ جدران وثياب وأثاث؟ أهذا أنا، كله أو بعضه؟ كبرت وتعلمت وجربت لأكون "شيئًا"؟ هل قمة نجاحي واعتدادي بنفسي أن ألخصها في "شيء" يملك مثله كثيرون ويزهد فيه كثيرون، غال كان أو رخيص؟ هل أنتظر خانة لي في صفوف البشر ودورًا في مسرح أيامهم وروضة يجنون ثمارها ويستريحون بأرضها وأنا منفصل عن عالم الأحياء، منحدرٌ من كرامة الإنسان إلى مستنقع الجماد وسراب المواد؟
(بِيضٌ صنائعنا سُودٌ وقائعنا خضْرٌ مرابعنا حمرٌ مَواضينا) ([1]).
صفحة الحياة لوحة غنَّاء أبدعها بارئ الأرض والسماء، فحفلت بعدد لامحدود من الألوان التي زيَّنت الكون، والإنسان، والنبات، والحيوان، والجماد. وتميَّز كل لون منها بدلالة جماليَّة ورمزيَّة جعلته أثيرًا لدى البعض ومنبوذًا لدى البعض الآخر حسب الجنس، والسن، والحالة البدنية والمزاجية؛ فاللون الأحمر معروف بدلالته المثيرة للأعصاب والرامزة للغضب والثأر، والأزرق باعث على الهدوء ورامز للصداقة والسكينة، واللون الداكن مُحبِط وجالب للاكتئاب ورامز للغموض والإبهام، والأسود دليل الفخامة والرِّفعة ورمز للحزن والموت، والأبيض دليل البراءة والصدق ورامز للسلام والصفاء... أما الأخضر فله التحية والسلام.
مَن مِنَّا لا يحب اللون الأخضر؛ الذي يزيِّن الحقول والبساتين، ويفتح ذراعيه مؤذنًا بالمرور عبر الإشارة في الطريق، ويزركش سندس أهل الحبور في جنَّات النعيم (عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ) ([2])؟ على ألا يغيب عن ذهننا أن النهج القرآني في تشبيه نعمة في الدنيا بأخرى في الآخرة إنما هو للتقريب لا للمضاهاة، فما مِن شبَهٍ بين نعمة في الدنيا وصنوها في الآخرة إلا في الاسم فحسب.
من الخطر أن يكون المرء أديبا. نحن قوم حالمون واسعو الخيال، مفرطو التفاؤل، متطرفو التشاؤم، نفلسف ما لا يُفلسف، نبحث عن الترميز في كل مكان، نجتهد في فك شفرته. ولهذا كله، نحن كائنات تصنع خيبة أملها بنفسها، وتبحث عن الأسى بملقط. هل أتجنى؟ اقرؤوا ما حدث لي.
كنت في زيارة لمتحف Wellcome Collection في لندن. كان متحفا طبيا عاديا إلى أن صادفت ذاك الهيكل العظمي؛ هيكل بلاستيكي مُصنّع لا يخيف البتة، معلّق بخيط معدني يتدلى من السقف. مهلا، يبدو أنه وقع وتفكك، وأخطأ عمال الصيانة في تركيبه! هذا الهيكل الذي ترون في الصورة يحتل فيه الحوض مكان الرأس، في حين هبط الرأس ليقبع مكان الحوض!
ويضج صدري بالفضول، ويحق لي ذلك فالمتحف يصف نفسه بأنه "مقصد لمن فضولهم لا بُرء منه". أبحث عن الموظفة لأنبهها إلى الخطأ، ثم يمور في صدري هاجس آخر؛ ماذا لو كان الأمر مقصودا؟ ماذا لو كان الفنان الذي صنع الهيكل ركّبه هكذا ليوصل رسالة ما. أتراجع عن مناداة الموظفة، أتراجع حتى عن الرغبة في سؤالها عن السر الذي قد يكون الفنان قصده، التقط صورة، وأعاهد نفسي على التأمل في المسألة.
آها! الآن أدركت معنى العبارة القابعة خارج المتحف: "كلما تمعنت فيه، ازدادت مخالفته للمألوف". الشيء الرائع حقا، الأصيل في روعته، يزيدك دهشة كلما تمعنت فيه، روعته لا تنضب، ومعانيه لا تنقضي، إنه المعنى المتجدد الذي لا يندرس.
كان المال ولا يزال وسيبقى على مر الأزمان والدهور فتنة للناس وامتحانًا موثوقًا ليميز الناس الخبيث من الطيب، والصادق من المنافق، والكريم من اللئيم، والمخلص من المرائي. وقد غدا المال اليوم، وكذلك الأمر دائمًا، من أجلى صور الفساد، والظلم، والاستبداد؛ خصوصًا بين زمرة الحكام الذين استأثروا بأموال الشعوب وجعلوها دولة بينهم وأقاموا بينها وبين الناس سورًا عظيمًا له باب باطنه فيه كنز الأموال، وادخارها، وتهريبها إلى بنوك الدول المتقدمة، وظاهره من قبله التدثر بأسمال الزهد، والدروشة، والحرص على أموال الشعب والرغبة عنها وعدم الطمع فيها.
وقد عملت الدول الديمقراطية والمتقدمة على دسترة أجور الحكام وقوننتها لئلا يتغول غير ذوي العفة منهم أموال الناس، ويأكلوها إلى أموالهم بغير الحق، ويحتازوا أرزاق العباد، ويكنزوا الذهب والفضة؛ فأسسوا لذلك أعرافًا سياسية وقانونية تحتذى من خلال محاسبة العديد من القادة والحكام، وإدانتهم بالتهم الموجهة إليهم، ومعاقبتهم بما يستحقون من صور الغرامات والحبس وغيرها.
أما في الدول المتخلفة، المستبدة عمومًا والدول العربية خصوصًا، فإن الأموال فيها مستباحة من قبل الحاكم، يصول فيها ويجول كما يشاء دون حسيب أو رقيب. ويا ليت الأمر يتوقف عند هذه العتبة؛ فأموال الأمة متاحة لكل من يدعي خدمة أعتاب الحكام وأنظمتهم في أي دائرة من دوائره، مهما كانت بعيدة عن بؤرة الحكم. والأدهى من ذلك غياب المحاسبة والعقاب، والأمرُّ منه بدعة العفو عما سلف مما يشجع ذوي النفوس المريضة على الخوض في أموال الأمة واستخلاص ما تسمح به مدة المكوث والاستقرار في المنصب، فيعمل "المسؤول" على اختلاس الأموال، واقتطاع الإقطاعات، وتفويت الأصول قبل أن تدق ساعة الصفر التي يجف معها هذا المنبع الغزير.
الصفحة 49 من 433